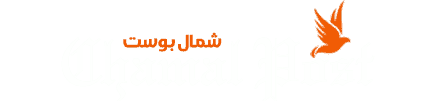في كل مرة تُستعاد فيها عبارة «زمن التفاهة»، يبدو كأنها تُلخِّص شعورًا عامًا بالخيبة من الفضاء العام، من المنابر الإعلامية إلى النقاشات السياسية، ومن مستوى الأخلاق العامة إلى ترتيب الأولويات في السياسات العمومية. وفي السياق المغربي، تتكثّف هذه العبارة لتعبّر عن مفارقات هشاشة الممارسة الديمقراطية من جهة، وحيوية المجتمع ومنسوب الوعي السياسي من جهة أخرى.
احتجاجات الشباب، وخاصة جيل Z، لم تَعُد حدثًا عابرًا. حركة Gen Z 212 نموذج بارز لهذا التحوّل؛ هي تُعبّر من جانب عن وعي مُتزايد بتراجع الخدمات الأساسية في مقابل الاستثمار في مشاريع كبرى لا يشعر الجميع بجدواها المباشرة. لكنها تكشف في المُقابل عن محدودية قدرة الشباب على إنتاج خطاب اجتماعي وسياسي واعٍ، كما تُعاني في الآن ذاته من تشتت تنظيمي بحكم اعتمادها على الفضاء الرقمي بدل الوسائط السياسية التقليدية. ويجعل هذا التشتت الاحتجاج عُرْضة للغموض وللتأويل كحركة انفعالية بلا رؤية واضحة، ما يربطها بما يسمى «التفاهة»، رغم أنه قد يكون نواة فعل سياسي جديد إذا اكتسب البنية والتنظيم.
مع ذلك، لا يمكن أو لا ينبغي اختزال «التفاهة» في الشباب وحدهم. وسائل التواصل الاجتماعي، بما تفرضه من إيقاع سريع ومحتوى استعراضي، صنعت فضاءً سياسيًا موازًيا يُغري بالسطحية ويمنح الانطباع بأن النقاش العمومي صار استهلاكيًا وخفيفًا. غير أن هذا المظهر ليس محليًا ولا خاصًا بالمغرب؛ هو ظاهرة عالمية تُعيد تشكيل معنى المشاركة السياسية وطُرُق التعبير عنها.
في كل الأحوال تظل الفجوة بين النص والممارسة أحد أبرز مظاهر التناقض في التجربة المغربية؛ فبينما تعِد النصوص الدستورية بإصلاحات واسعة وبمبادئ الشفافية والمحاسبة، تبقى هذه الوعود غير مُجَسَّدة بما يكفي في الحياة اليومية للمواطن. وتزداد هذه الفجوة اتساعًا مع ما يعتبره البعض تراجعًا في دور المجتمع المدني بفعل محاولات لتقييد مساحة عمله أو تمييعه، وفي المُقابل تنامي ما يوصف بـ«تحالف السلطة والثروة» الذي يعمّق الإحساس بأن القرار السياسي محكوم بمنطق المصالح الاقتصادية أكثر مما يحكمه منطق التمثيل والمواطنة.
كل هذا يجعل السؤال عن تراجع المشروع الديمقراطي المغربي سؤالًا مشروعًا. فالتقارير الدولية تُصنِّف المغرب ضمن «الديمقراطيات الهجينة»، والفاعلون السياسيون يجدون أنفسهم في مشهد يميل فيه النظام إلى تفضيل الاستقرار على الإصلاح العميق. لكن، في المُقابل، لا يزال المواطنون المغاربة يُظهِرون تَمسُّكًا قويًا بفكرة الديمقراطية، كما تُؤكد نتائج استطلاعات الرأي، مما يدل على أن الطلب المجتمعي على التغيير حيّ وفعّال، حتى لو كانت أدوات التعبير عنه تتطور ببطء.
ربما يكمن جوهر الإشكال في هذا التوتر في دولة تسعى إلى موازنة التحديث مع الحفاظ على استقرارها السياسي والاجتماعي، ومجتمع يُطالب بديمقراطية أعمق وتجسيد فعلي للوعود المؤسسية، وأحزاب تقليدية لم تعُد قادرة على مواكبة التطور السريع للمجتمع وملامح تآكل دورها كمحرك للفعل السياسي وتأطير المجتمع. وفي خضم هذا المشهد، تتولد صور عن «زمن التفاهة» وقد تعكس هذه الصور في الواقع أزمة أعمق، أزمة معنى، وأزمة ثقة، وأزمة تمثيل.
احتمالات المشهد السياسي المغربي القادم
في ضوء هذه التحولات، تتبدى أمام المغرب مجموعة من السيناريوهات الممكنة. قد يستمر التصاعد في الخطاب الاحتجاجي للشباب، ويأخذ أشكالًا أكثر تنظيمًا وضغطًا، مما قد يدفع الدولة إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاجتماعية. وقد تختار السلطة مقاربة إصلاحية من أعلى، تقوم على تحسين بعض آليات الشفافية أو تجديد جزئي في الحياة الحزبية، دون المساس ببنية السلطة الفعلية. ومن المُحتمل أن تحاول الأحزاب التقليدية إعادة بناء نفسها، أو أن تظهر تحالفات سياسية جديدة أكثر قدرة على مخاطبة الفئات الشابة وغيرها التي فقدت الثقة في الوسائط القديمة. وعلى الجانب المقابل، قد يتأزم الوضع إذا لم تُستجب المطالب الاجتماعية والسياسية، بما يفتح الباب أمام تراجع ديمقراطي أوسع. ومع ذلك، يبدو أنّ السيناريو الأقرب للواقع هو استمرار التوازن الهش القائم على إصلاحات محسوبة، واحتجاجات مستمرة ومُتَحَكَّم فيها، ونظام سياسي يحافظ على صيغته «الهجينة» التي تجمع بين مظاهر الديمقراطية وبنية مركزية للسلطة.
في النهاية، ليس «زمن التفاهة» قدَرًا محتومًا، ولا هو تشخيص نهائي لحال المجتمع المغربي. قد يكون مجرد مرآة تُظهر التوتر بين منطق الصورة ومنطق المضمون، بين وعود الإصلاح وواقع الممارسة، وبين تطلعات شعب يريد مزيدًا من العدالة والديمقراطية ونظام سياسي يسعى إلى إدارة التغيير بأقل قدر من المُخاطرة.
رغم كل التحديات، لا تزال بذور النضج السياسي قائمة، تنمو في الشارع والجامعات والفضاء الرقمي، وتُعيد تشكيل أسئلة المستقبل بصوت أعلى وأوضح من أي وقت مضى.