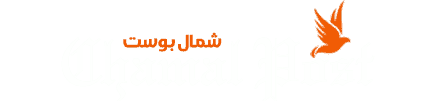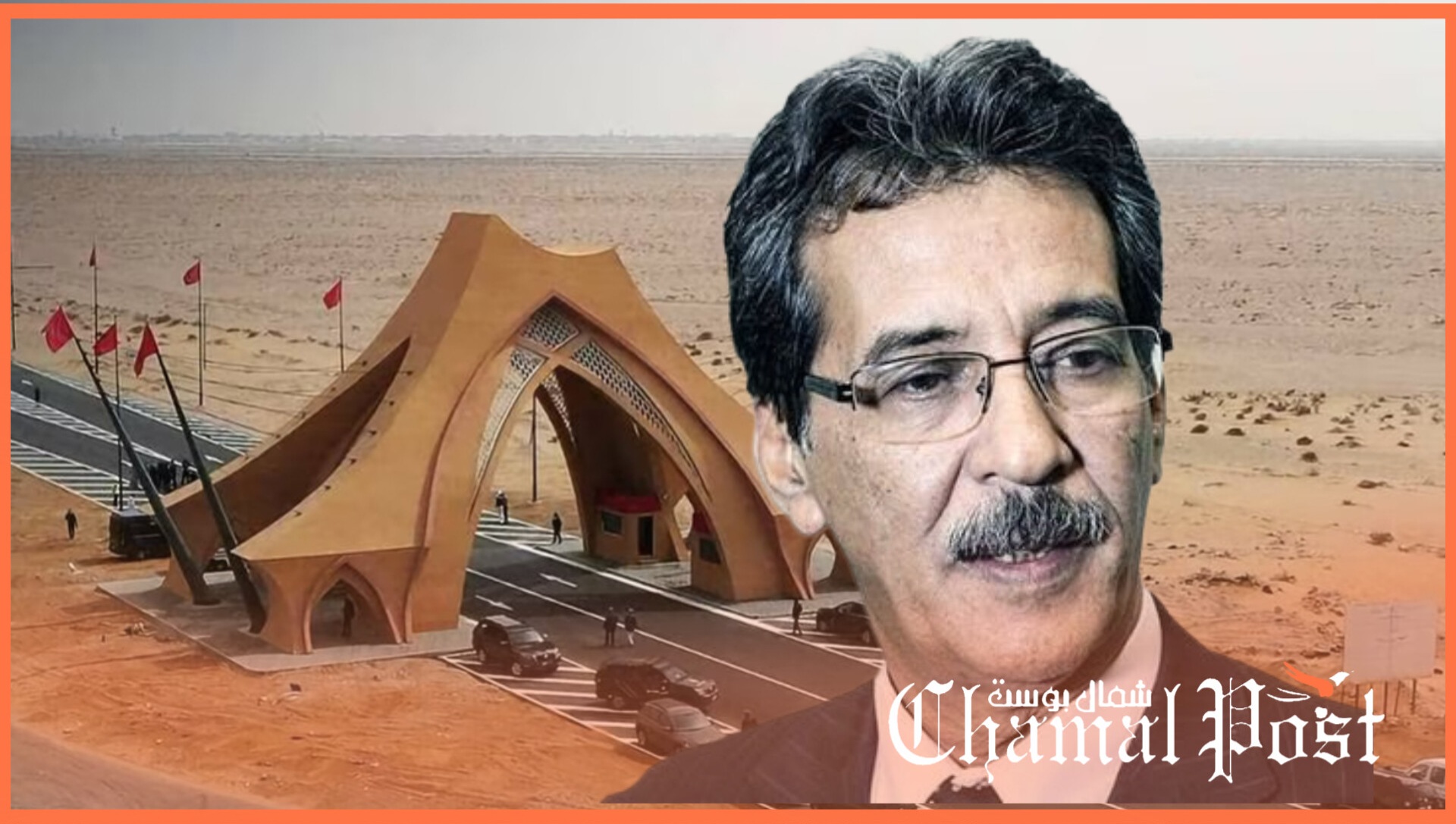وانا في مقدمات اشتغالي على مقال ” سوسيولوجيا الفساد الجامعي …” استوقفتني مقالة امتزج فيها البعد الروائي والفني وحتى الفكاهي للتعبير عن الصورة القاتمة عن وضعية الجامعة. فالفساد ككائن متحرك و خاضع للتحولات المجتمعية لم يعد ينظر اليه كسلوك فردي ينحصر داخل وحدات معزولة كانت تشكل استثناءات في بعض حالات الفساد من اجل المنفعة الخاصة.
ان مقولة “ظهور الفساد كان مرتبطا بسيرورة التحديث” ستتضح معالمها من خلال كتابات هنتنغتون و ماكمولان، فلم يكتف هؤلاء الباحثون بتأصيل الفساد هيكليا، بل رأوا فيه وظيفةً وظيفية. وقد استوفى الفساد متطلبات محددة مرتبطة ببناء اقتصاد السوق والدولة الحديثة، كما سهل المشاركة السياسية. “على مستوى عال، يرسي الفساد جسرا بين أصحاب السلطة السياسية والمسيطرين على الثروة”، وعلى مستوى أدنى، يسهم في دمج الفئات التابعة في النظام السياسي، كما حفز التنمية الاقتصادية من خلال تمكين تراكم رأس المال والالتفاف على العقبات البيروقراطية، وساعد في بناء الأحزاب السياسية، هذا الرأي قد بين وظيفوية الفساد في بناء معايير كونية لا تحتكم الى أخلاقيات ثابتة.
اذا امام سيرورة التحديث التي تخضع لها مجتمعات الدول النامية هل ينظر الى الفساد كأداة للبناء في سبيل المصلحة العامة أو كأداة للمنفعة الخاصة ( أفراد، جماعات…)؟. سيمكننا الفضاء الجامعي من رؤية نافذة لتمظهرات متعددة للفساد وكمختبر منتج لسلوكيات لم تعد تمثل استثناءا امام التمثلات الاخلاقية العامة حول الفساد، في سياق هذا القول ندرج مقالة “سرديات الفساد في الجامعات العربية” كما كتب الباحث نبيل سليمان (كتبت في “ضفة ثالثة” مقالة بعنوان (تمثيلات فنية وروائية للمواجع الجامعية في سورية).
وهنا أتابع القول في جامعات عدد من الدول العربية، مبتدئًا بما كتب الباحث السوري محمد عبد الرحمن يونس تحت عنوان “الأستاذ الجامعي والجامعات العربية المعاصرة: منظومة الفساد والاستبداد” مستلهمًا الحياة الجامعية السورية، معدّدًا من العورات الجامعية الصارخة والخطيرة: الجوسسة الطلابية، حيث لرئيس الجامعة عيونه، ولعميد الكلية، ولرئيس القسم، وأضيفُ: للفروع الأمنية، ولاتحاد الطلبة، ولنقابة أساتذة الجامعة.
كما عدد عسكرة الجامعة والوشاية ونظام الأحقاد والمنافسة غير الشريفة… وأضيفُ: تدني الرواتب، بيع الأسئلة، بيع الشهادات بأبحاث مسروقة، العصبوية الجهوية أو الطائفية أو المذهبية أو الإثنية أو الحزبية والسياسية. يضيف الباحث في وصفه لقراءته لسعيد بن كراد (لا يكتب سعيد بنكراد عن الجامعة في المغرب فقط، بل هو يكتب عن جامعات عربية كثيرة وتتكاثر، حيث صارت عضوية مجلس المؤسسة أهم من تأليف كتاب”.
من جامعة مكناس إلى جامعة فاس إلى جامعة الرباط يهتك بنكراد العورات الجامعية والمجتمعية، من اختفاء الحرم الجامعي، إلى تحولات الجامعة إلى (إدارية) بدعوى الإصلاح، فصار الطلبة يتلقون ربع ما كانوا يتلقونه من قبل، وتحوّل كثير من مسؤولي الشُعب إلى موظفين طبيعيين عند العميد. وكان قد بات الأستاذ الجامعي لا يسأل في الجامعات المغربية عن نشاطه العلمي، ولا عن أبحاثه ومنشوراته وطبيعة الدروس التي يقدمها، فقد وصل التسيّب إلى الحد الذي يسمح فيه للأستاذ أن يقول ما يشاء خارج أي ضابط علمي أو تربوي.
أما من يبحثون فهم قلة، وباتوا يعتبرون خطرا على الجامعة، فيهمشون كما كان الأمر في سبعينات القرن الماضي مع مجموعة من أسماء كبيرة ألحقوا بمؤسسات لا قيمة لها في النسيج الجامعي المغربي.
لا، لا يكتب سعيد بنكراد عن الجامعة في المغرب فقط، بل هو يكتب عن جامعات عربية كثيرة وتتكاثر، حيث صارت عضوية مجلس المؤسسة أهم من تأليف كتاب، فالعضوية لها نقاط في الترقي أكبر من (تهراس الراس) أي الكتابة والتدريس، مما جعل أساتذة يفقدون احترامهم لأنفسهم، يقدمون ملفات فارغة، وشعارهم: “الأستاذ ينصر أخاه الأستاذ على حساب أي شيء”.
قد يختلف الرأيان في هذا الوصف و يرسم صورة سوداء عن الجامعة و هو ما قد نختلف معه اذا لم يوضع تحت مجهر البحث الاكاديمي الرصين و تتبع هذه الظاهرة بعيدا عن كل لغط ايديولوجي.
بعض المصادر:
https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/opinions/2022/11/15
https://compass.onlinelibrary.wiley.com/…/soc4.70020 A Comparative Historical Sociology of Corruption